قصة نمو حضري غير منظّم، اعتماد على السيارات، وإخفاقات متعاقبة في إنشاء نظام نقل عام حقيقي. فحتى اليوم، وفي سياق يتّسم بعدم الاستقرار الاقتصادي والمؤسسي، لا تزال الرحلات اليومية لملايين المواطنين مصدراً للقيود، التفاوتات، والتوتّرات، لكن أيضاً للإبداع واستراتيجيات التكيّف الفردية.
لعقود من الزمن، كانت الطرقات والنقل في لبنان مؤشّراً للقوّة الدافعة للتنمية. فتروي شبكة الطرقات في التسعينات، تسارع تاريخ الطرقات اللبنانية بعد الحرب الأهلية، إذ ركّزت الدولة على إعادة بناء البنى التحتية المدمّرة، لكنّ إعادة التأهيل هذه لم تترافق مع استراتيجية متماسكة للتنقل. وازدادت كثافة النسيج العمراني لبيروت من دون أي رؤية شاملة، وسرعان ما اكتظّت المحاور التي تربط العاصمة بالبقاع والجنوب والشمال، وهي لا تكفي للبنانيِّين أنفسهم، فكيف تلبّي اليوم حركة السياحة، والضيوف النازحين؟
علمًا أنّه في وقت مبكر من العام 1993، كان مجلس الإنماء والإعمار يصدر تحذيرات عن الازدحام المستقبلي في بيروت الكبرى، لكنّ هذه الإشارات لم يتبعها تخطيط مستدام. فكان نموذج التنقّل يتمحوَر حول السيارات، مع استثمارات في توسيع الطرقات وإصلاحها، لكن غابت سياسة نقل عام واسعة النطاق.
وعليه، كان لهذا الافتقار إلى الرؤية عواقب بعيدة المدى. فبحلول نهاية التسعينات، كانت السيارات تستحوذ على ما يقرب من 70% من وسائل النقل في بيروت الكبرى. وأشارت خطة النقل لعام 1995 إلى أنّ 9% فقط منها كانت تتمّ بواسطة الحافلات العامة الصغيرة وأقل من 1% بواسطة الحافلات العامة الكبيرة.
بعد مرور ربع قرن من الزمن، لم يتغيّر الوضع إلّا قليلاً: فالاعتماد على السيارة لا يزال القاعدة، والبدائل لا تزال هامشية. فثقافة السيارة، التي غالباً ما يُنظر إليها كرمز للأمان، الاستقلالية، وحتّى الاحترام الاجتماعي، قد ترسخت في العادات، ويزيد من حدّتها غياب التنظيم، وغياب الحوافز لتفضيل وسائل النقل العامة.
اليوم، تتنافس سيارات الأجرة، “السرفيس”، الحافلات، والشاحنات على الطرق نفسها بعيداً من تقديم بديل موثوق به للنقل العام، وغالباً ما يكون ذلك من دون تنسيق أو منطق مشترك بين الوسائط. ففي شوارع بيروت وضواحيها، يؤدّي هذا المشهد الفوضوي إلى إبطاء حركة المرور، ويفضي إلى انسداد الأماكن العامة ويولِّد سلوكاً اقتصادياً للبقاء على قَيد الحياة بين السائقين، الذين يخفّضون تكاليفهم على حساب السلامة والبيئة. كما تساهم التوقفات العشوائية، السرعات الزائدة، وغياب المحطات الثابتة في إيجاد تجربة غير مضمونة للركّاب.
إنّ الأثر الاقتصادي لهذا الوضع مريع، فالاختناقات المرورية المزمنة تكلّف البلاد مليارات الدولارات. فمنذ العام 1997، كان الازدحام يمثّل 15% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقاً لبعض التقديرات. واليوم، لا تعني طوابير السيارات المتوقفة في ساعة الذروة إهدار الطاقة والوقود فحسب، بل خسارة الإنتاجية وتدهور الحياة اليومية. في ما يخصّ الشركات، يعني التأخير اللوجستي انخفاضاً في القدرة التنافسية، وارتفاعاً في أسعار السلع الاستهلاكية. أمّا لدى الأُسر، فإنّ كل ساعة تضيع في حركة المرور تزيد من العبء النفسي، وتقلّل من الوقت المتاح للأنشطة العائلية والاجتماعية، و”النطرة بتصير دهور”.
علاوةً إلى ما ذُكِر، فثمّة آثار بيئية وصحّية، إذ تجاوزت مستويات تلوّث الهواء في بيروت معايير منظمة الصحة العالمية بكثير. وتساهم الجسيمات الدقيقة، المنبعثة بوجهٍ رئيسي من حركة المرور على الطرق، في زيادة أمراض الجهاز التنفّسي، والقلب، والأوعية الدموية. ففي أوائل العقد الأول من القرن الـ21، قُدِّر عدد الوفيات التي تُعزى إلى تلوّث الهواء في العاصمة وما حولها بحوالى 800 حالة وفاة سنوياً. ولم يكن لمحاولات التنظيم، سوى تأثير محدود في غياب استراتيجية متماسكة.
ثمّة عنصر آخر يندر مناقشته لكنّه حاسم، وهو العلاقة بين الضرائب والتنقّل في لبنان. فالدولة تستمدّ نسبة كبيرة من إيراداتها من الضرائب على الوقود وواردات السيارات. يخلق هذا الاعتماد على السيارة في الميزانية حلقة مفرغة؛ فكلّما زاد عدد اللبنانيِّين الذين يقودون السيارات، زادت الجباية التي تحصِّلها الدولة، وفي هذا النموذج، تصبح السيارة ضرورة اجتماعية ومصدراً للإيرادات الضريبية في آنٍ معاً، على رغم من أنّها تمثّل عبئاً اقتصادياً وبيئياً متزايداً على المجتمع. وقد ساهمت الميزانية قصيرة الأجل في عرقلة الإصلاحات الهيكلية، ممّا عزّز منطق الدولة التي تعتمد على رَيع السيارات بدلاً من التخطيط المستدام.
كشفت الأزمة الاقتصادية في العام 2019 عن مدى ضعف نظام التنقل، فقد أدّى نقص الوقود وارتفاع الأسعار إلى الحدّ من التنقّل موقّتاً، ممّا أجبر بعض الأُسر على الحدّ من تحرّكاتها، أو إعادة تنظيم أماكن إقامتها. واضطّر العديد من العمّال والطلاب إلى الاستقرار بالقرب من بيروت في أيام الأسبوع قبل العودة إلى مناطقهم في عطلات نهاية الأسبوع، وهو تنقّل دائري مقيّد يعكس الاختلالات المناطقيّة في البلاد. وفي حين يُبيّن هذا التكيّف قدرة اللبنانيِّين على الارتجال في مواجهة الأزمات، إلّا أنّه يُبيّن أيضاً غياب إطار عمل جماعي يُسهِّل التنقل الميسّر والمستدام.
هكذا، يطرح هذا الوضع سؤالاً جوهرياً: هل يستطيع لبنان الاستمرار في تمويل ميزانيّته بالاعتماد على السيارة، أم أنّ عليه إعادة النظر جذرياً في نموذج التمويل والتنقل؟
تُعَدّ خطوط الحافلات الجديدة التي تمّ تدشينها في عامي 2024 و2025 علامة مشجّعة، لكنّها لن تكون كافية من دون إصلاح ضريبي موازٍ. ولكسر هذه الحلقة المفرغة، يجب إعادة توجيه جزء من ضرائب السيارات إلى صندوق مخصّص للبنية التحتية للنقل العام، بالتالي ضمان استخدام تنقّل المواطنين ليس للحفاظ على الوضع الراهن المُكلِف، لكن لبناء نظام جماعي ومستدام ومنصِف.
كذلك، في حين أنّ هذه الخطوط الجديدة لا تكفي لحلّ عقود من التقصير، إلّا أنّها تُمهِّد الطريق لتغيير رمزي: فللمرّة الأولى منذ فترة طويلة، تتحمّل الدولة مسؤوليّة جزء من تنقّل المواطنين خارج بيروت. وعلى رغم من أنّ هذه النهضة لا تزال متواضعة، إلّا أنّها قد تكون رافعة لتحفيز الاقتصاد، إعادة ربط المناطق، وتخفيف سوء توزيع الفرص الذي يعاني منه سكان الضواحي. كما يظهر أيضاً أنّ المواقف آخذة في التغيّر: فالعديد من المستخدمين مستعدّين لاعتماد وسائل النقل العام إذا أصبحت موثوقة ونظيفة وآمنة.
ومع ذلك، لا يزال الطريق إلى التنقل المستدام مليئاً بالعقبات. فالحَوكمة المجزّأة بين الوزارات والبلديات والنقابات العماليّة تحول دون وضع سياسة وطنية متماسكة. وقد ظلّت المشاريع التي يمولها البنك الدولي أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ التسعينات حبراً على ورق، وغالباً ما تعطّلت بسبب الخصومات السياسية أو الأزمات المتتالية.
ختاماً، يواجه لبنان خياراً تاريخياً، إمّا الاستمرار في الاعتماد على السيارات، بتكاليفه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة، أو الاستثمار في نظام نقل جماعي منظّم قادر على تحسين نوعية الحياة، وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود. وعلى أنّ الخطوط الجديدة تمثّل خطوة أولى، لكن يجب أن تكون مصحوبة بإصلاحات أوسع، كتحديث أسطول الحافلات، تطوير الممرّات المخصّصة للدراجات، تخفيض الأجرة، رقمنة المعلومات، إصلاح شبكة الخطوط الحديدية، وإيجاد شبكة ترام أو ميترو… وقبل كلّ شيء، إطار مؤسّسيّ واضح.
وأخيراً، يجب أن توضع القضية البيئية في صميم أيّ إصلاح: فالحدّ من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين جودة الهواء هما من ضرورات الصحة العامة وأهداف الاستدامة، وأن يكون مشوارنا ما “بدّو دهور”.





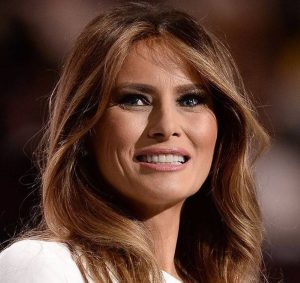








Recommended for you
مدينة المعارض تنجز نحو 80% من استعداداتها لانطلاق معرض دمشق الدولي
طالب الرفاعى يؤرخ لتراث الفن الكويتى فى "دوخى.. تقاسيم الصَبا"
تقديم طلبات القبول الموحد الثلاثاء و640 طالبا سيتم قبولهم في الطب
البريد المصري: لدينا أكثر من 10 ملايين عميل في حساب التوفير.. ونوفر عوائد يومية وشهرية وسنوية
سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين
الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي